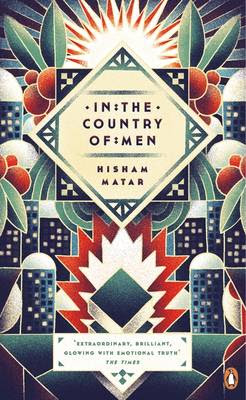لقد كان كتاباً مرهقاً.. مرهقاً جداً... لم
أتوقع أبداً أن يكون الكتاب هكذا.
لقد سمعتُ عن الكتاب كثيراً، منذ صدوره وإلى اليوم
(تقريباً 10 سنوات). وكيف لا، والكاتب هشام مطر ليبي حقق شهرةً في الخارج، في
العالم الآخر. في السنوات الأولى لصدور الكتاب ربما كنا نتجاهله لأنه كتاب يتحدث
عن جماهيرية القذافي، يتحدث عن ليبيا التي كنا لا نتحدث عنها إلا همساً بعد النظر
حولنا ألف مرة. ربما هذا كان سبباً لاواعياً في تجاهل الكتاب، بالرغم من أن مثل
هذه الكتب الممنوعة والخطيرة كانت خطيئة يحرص كثيرون على ارتكابها زمن القذافي،
كانت الخطيئة الكبرى، المتعة القصوى، التمرد السري البائس ضد هذه البلاد وهذا
الطاغية – الكتب الممنوعة كانت سلعةً أثمن من المخدرات وأقوى نشوةً منها، فربما لم
يكن هذا السبب فعلاً. وإن كنت لا أعلم هل هذا السبب له دوره أم لا، فإنني أعلم
يقيناً أن السبب الأساسي في إهمالي لقراءة الكتاب هو أنني كنتُ دائماً أشعر بأن
هذا الكتاب ليس مهماً بالنسبة لي. ألفه رجلٌ لم يعش في ليبيا فعلاً، عاش أغلب
حياته خارجها. ألفه بالإنجليزية. كان يكتبه للعالم، وليس لليبيا. كان يتحدث عن
أشياء أعيشها، وتجارب اختبرتها. فلماذا سأقرؤه؟
ربما لم أكن مخطئاً فيما يخص طبيعة الكتاب،
ولكنني كنتُ بلا شك مخطئاً في تجاهله.
مؤخراً أثار كتاب هشام مطر الجديد
"العودة" ردود فعل عالمية إيجابية بشكل كبير. لقد فاز بجائزتين مرموقتين
حتى الآن (حسب علمي). قلتُ في نفسي ربما حان الوقت لأقرأ كتبه. اشتريت "في
بلاد الرجال" و"العودة"، وبقيتُ متردداً بخصوص الكتاب الذي في
المنتصف "اختفاء". وكالعادة دائماً بقيتُ أتعطل وأتعطل وأقلب الصفحات الأولى
لرواية "في بلاد الرجال" وأؤجل الأمر. إلى أن فاز كتاب
"العودة" بجائزته الثانية مؤخراً. حسناً، هذه السنة أريد القراءة
لكُتَّاب ليبيين والتعرف على الأدب الليبي. هشام مطر كاتب ليبي، وإن كنتُ مازلتُ
متوجساً من كتابه هذا باعتباره كتاباً "أجنبياً". حفزتُ نفسي بخبر
الجائزة الجديدة وبمشروع قراءتي الليبي. وبدأت في قراءة رواية "في بلاد
الرجال".
لقد كان فخاً!
بداية الكتاب كانت مليئة بالابتسامات. إنها
ليبيا. إنها بلادي التي تربيت فيها! نعم، سليمان (بطل الرواية والراوي) كان يعيش
في طرابلس، وطرابلس مختلفة نسبياً عن بنغازي، وفي فترة زمنية تسبق طفولتي. لكنه
كان يعيش حياةً شبيهةً بحياتي. حياة صغيرة. عائلة صغيرة، شارع واحد، جيران. كنتُ
أبتسم كثيراً، كل شيء كان يجعلني أشعر بالحنين. حتى اسم دلع البطل الذي يناديه به
البعض "سلومة"، كان يجعلني أشعر بالحنين بالرغم من أنه ليس اسمي، ولكنني
كنت أقرأ اسم الدلع هذا بلهجة ليبية، أقرأ فيه الطفولة. إن هشام مطر يتذكر طفولته
بوضوح دقيق، وضوح يلتقط حتى نبرة الناس وحركاتهم بالضبط وهم يلقون التحية على
"سلومة" ويقولون له "يا بطل". لقد جذبني الكتاب بهذه
النوستالجيا. احتواني، وطمأنني، ولف ذراعيه حولي.. ولم أكن أعلم أنه كان يمد يده
إلى داخل صدري...
لقد بدأ الكتاب يمد يده إلى قلبي...
شيئاً فشيئاً بدأت الأحداث تتسارع.. شيئاً
فشيئاً كانت يد الكتاب تقبض على قلبي.. شيئاً فشيئاً كان هشام مطر يستعيد كل مشاعر
الطفولة في الجماهيرية: كل عدم الفهم الطفولي لتصرفات الكبار وخوفهم وسرية
أحاديثهم وهمسهم وتحذيراتهم من تكرير الكلام، كل الرعب مما يحدث للآخرين وتسمعه
وتراه، كل الخوف حتى من سماعة الهاتف والمكالمات.. لقد انغلقت يد الكتاب على قلبي،
وعصرته! عصرت منه كل مشاعر وذكريات الطفل الذي يعيش في بلاد يتعلم فيها
الخوف وهو صغير دون أن يفهمه، وشيئاً فشيئاً يكبر ليفهم تماماً سبب هذا الخوف
فيبدأ في تعليم الأطفال هذا الخوف من جديد: لا تذكر ما سمعته لأحد! لا تُكرر هذا
الكلام! اذهب والعب قليلاً أريد الحديث مع عمو، لا تتحدث في الهاتف عن شيء سلم
عليه واعطني السماعة، لا تخرج هذه الكتب من البيت، لا تتحدث مع أولاد هذا الجار،
ولا تعد للعب مع أولاد ذاك... لقد عصر الكتاب قلبي وأخرج من داخلي كل تلك المشاعر
القديمة... مشاعر الطفل الخائف الذي لا يفهم شيئاً، ومشاعر الرجل الذي يكبر ويفهم
ويحمد الله أنه لم يفعل شيئاً خاطئاً في صغره ويبدأ فوراً في الحذر حول الأطفال...
لقد عصر الكتاب قلبي!
وأرهقني.. كان وكأنه يفرض علي إعادة عيش تجارب
نفسية مؤلمة... لا أذكر أن فرداً واحداً من عائلتي الممتدة الكبيرة، أعني أخوالي
وأعمامي، كان يؤيد القذافي أو يدعمه، بل كان الجميع ينتقده ويتحدث عن جرائمه،
غالبيتهم كانوا يتحدثون عن المملكة، "العهد البايد"
(و"الباهي" في روايات أخرى)، غالبيتهم يقرأون ويتبادلون الكتب الممنوعة
بسرية... وكثيرون سُجنوا وتعذبوا في سجون القذافي، غيرهم مهاجرون لم يكونوا
يستطيعون العودة لأسباب أمنية، وآخرون كانوا معارضين صريحين في المنفى... كان
هنالك الكثير من الرفض للقذافي في العائلة، وكل ذلك جعل نقد جماهيرية القذافي
شيئاً عادياً داخل بيوت العائلة، ولكنه أيضاً زاد من الخوف.. عتبات البيوت كانت
المكان الذي تخلع فيه حذاءك وحذرك، وحين تخرج ترتدي الاثنين وتنطلق في عالمٍ من
الصمت. الكلام مسموحٌ به داخل البيت فقط. جدران بيوت العائلة وحدها ليست لها آذان،
لكن بقية جدران المدينة كلها آذان وأعين.
هشام مطر أعادني إلى طفولتي، وجعلني أعيد عيش كل
ذلك الرعب وعدم الفهم. لم أكن أخاف على سليمان، سلومة.. لم يكن رعبي هو على سلومة
بطل الرواية الصغير، وأنه يتوجَّب عليه أن لا يتحدث مع رجال اللجان الثورية، أن لا
يعطيهم معلومات، أن يكون حذراً، وأن يسمع كلام أهله.. لم أكن أخاف على سلومة، كنت
أخاف على نفسي... ياه كم يتذكر هشام مطر طفولته الليبية. لقد اقتنعت بأنه بالفعل
كتب ليبيا كما هي.
لقد أرهقني الكتاب لدرجة أنني وصلتُ مرحلةً كنت
أخشى فيها من العودة لقراءته. لقد حاولت، بعد أحد الفصول الذي كاد أن يقتلع قلبي
من مكانه، حاولت أن أغادر جسدي قبل أن أعود للقراءة! قلت في نفسي يجب أن أكمل
قراءة الكتاب، ولن أستطيع فعل ذلك وأنا موجود! لا أستطيع أن أترك قلبي وروحي في داخلي
ليقبض عليهما الكتاب مرةً أخرى ويعصرهما! ولكن، لحسن الحظ أو بؤسه، كان ذلك الأثر
قد اختفى حين بدأت الرواية تصف أحداثاً حقيقية.
الرواية كلها حقيقية. كل تفاصيلها. ولكن ما
أعنيه هو أنه حين بدأت الرواية تصف أحداثاً نعرفها جميعاً ونعرف بشاعتها وعشنا مع
رعبها طويلاً نُغذي بها رفضنا الدائم للقذافي، حين بدأت الرواية تصف هذه الأحداث
وتغيرها قليلاً (للتماشي مع طبيعة الرواية "المتخيلة" المبنية على أحداث
واقعية)، فقدت الرواية سيطرتها العنيفة علي، أعني أن قبضتها العاطفية التي كانت
تعصر قلبي ارتخت.
حدث ذلك بالتحديد مع أحداث إعدام الصادق
الشويهدي رحمه الله، طبعاً أقصد الشخصية في القصة المبنية على الصادق الشويهدي
رحمه الله. إنها قصةٌ أعرفها جيداً، حفظتها، رأيت صورها، أعلم كل شيءٍ حولها
واكتسبت تجاهها مناعةً من نوعٍ ما. إن كان يمكن وصف الاعتياد على الألم بأنه
مناعة، فأنت ستشعر بالألم، كل ما في الأمر أنه لن يكون جديداً. هذه الأحداث كانت
منعطفاً في الرواية، ربما كان منعطفاً يمثل انتقال الرواية من رواية تشارك
الليبيين ذكرياتهم، إلى رواية تخاطب العالم غير الليبي – العالم الآخر. في ذلك
المنعطف تحررتُ من الرواية، لم تعد تقبض علي، وكأنها تركتني وذهبت تبحث عن آخرين
لتقبض على قلوبهم وتعصرها (إحدى الصديقات، التي ليست من ليبيا، أخبرتني عن صدمتها
وخوفها من الرواية وعن ألمها الذي لا تريد تذكره والذي تسببت به هذه الأجزاء من
الرواية.. يبدو أن الرواية بالفعل نجحت في القبض على قلوب غير الليبيين في هذه
الأجزاء...).
بعد هذه الأجزاء، كانت هنالك أجزاء قصيرة أخرى
قد تعود بالقارئ الليبي إلى واقعه وتثير فيه مشاعر دفينة. هي الأجزاء التي تتحدث عن
المعتقلين والبوح بأسماء الرفاق والخيانة والبطولة والصمت. إنه شيءٌ بشعٌ بلا شك،
أن ينكسر الإنسان تحت التعذيب ويُدفع نحو الخيانة. ولكن ذكرياتي عن الأمر، القصص
التي كنت أسمعها طوال الوقت عن المعتقلين ومنهم، مختلفة قليلاً عما في الرواية.
الرواية تضع تلك الصورة المعتادة لخيبة الأمل في الخيانة والتقزز منها، وربما هذا
للتوافق مع إحدى عبر الرواية التي يريدها هشام مطر، والتي سأذكرها لاحقاً. الواقع
في ليبيا كان مختلفاً. كان التعذيب قد وصل بالناس إلى تقبل الخيانة. نعم، لهذه
الدرجة كان الوضع سيئاً. لقد سمعتُ قصصاً كثيرةً جداً عن رفاق يعتذرون لبعضهم
ويسامحون بعضهم، ولم يكن الأمر محصوراً بالرفاق في جريمة معارضة النظام، فهنالك
قصص كثيرة عن أشخاص أبرياء لا علاقة لهم بشيء ينهارون تحت التعذيب وينطقون بأسماء
لأشخاص آخرين أبرياء. أحد هؤلاء أعطى المحققين اسم أحد أصدقائه، وحين التقيا في
السجن اعتذر له وقال له قلت في نفسي أنت لن تعترض على مؤازرة صديقك والتسكع معه
قليلاً، خاصةً وأنهم هددوني بإحضار أبي وأمي للسجن! لقد اختار الرجل البريء أن
يعطيهم اسم صديق هو الآخر بريء لأن صديقه سوف يتفهم، وبعد سنوات السجن الطويلة
يروي لك القصة ضاحكاً. ونعم، كانت هنالك قصص بطولية، سوف تسمع عن أشخاص اشتهروا
بأنهم لا يمكن كسرهم وإخراج ولو حرف واحد من بين شفاههم، سوف تسمع عن أشخاص لم
يكونوا يدخلون لجلسة تعذيب ولكن لجلسة مصارعة فيلكمون ويركلون ويعضون معذبيهم! سوف
تسمع عن أشخاص كانوا يعترفون على أنفسهم ويبرئون رفاقهم. ولكنك سوف تدرك أن الجميع
تقبلوا الخيانة حين تكون نتيجةً للتعذيب. ولكن ليس الوشاية! هذه كانت آفة البلاد،
وبالتالي كانت أكبر خطيئة يمكن ارتكابها في أعين الناس. التبليغ عن شخص ما. ولكن
في السجن، تحت التعذيب، كانت الخيانة مختلفةً تماماً...
بعد أن تعبر الرواية ذلك المنعطف، أعني بعدما
شعرتُ أن الرواية بدأت في مخاطبة العالم، فهي تنتهي بثلاثة أصوات...
صوت ليبيا يتراجع في الخلفية، يصبح قصصاً بعيدة.
يعرفها كل الليبيون جيداً، ويعيشونها، ولا تعود الرواية تشدهم فعلاً – على الأقل
هذه تجربتي، القبضة ارتخت من على قلبي وذهبت تبحث عن ضحايا آخرين!
صوتٌ آخر أعلى يخاطب العالم الخارجي (أو ربما
يسمعه العالم الخارجي بوضوحٍ أكثر)، صوتٌ يقول بأن هنالك عالم بالرغم من أنه يقع
تحت الشمس مباشرةً ويكاد يحترق تحت ضوئها إلا أنكم لا تعرفون عنه شيئاً ولا ترونه،
وفي هذا العالم لا نهاية هوليوودية سعيدة، في هذا العالم الدماء بشعة وليست شيئاً
نبيلاً بطولياً، في هذا العالم ينهار الأبطال، يبكون، يتبولون على أنفسهم، يخونون
رفاقهم، لا يوجد بطل يحتفظ بصمته ويموت مرفوع الرأس (وهذه العبرة التي ربما تكون
السبب في تصوير هشام مطر للخيانة في صورة مخزية قد تخالف الواقع). في هذا العالم
الحياة ليست طبيعية. أشعر بأن هذا الصوت موجه للعالم الخارجي، العالم حول ليبيا،
فهذه الحياة "غير الطبيعية" التي لا تنتهي نهايةً سعيدة هي الحياة التي
نعيشها، الحياة التي كنا نعيشها تحت القذافي، والتي مازلنا نعيشها في ظروف أسوأ
اليوم...
الصوت الثالث هو صوت الليبي المنفي. صوت الليبي
الذي يقول بأنه انقطع عن بلاده بسهولة كبيرة. لم يستبدلها ببلاد أخرى، ولكن حبل
الوطنية الرفيع جداً (كما يصفه هشام مطر، معقباً بأن هذا قد يكون سبب هوس الجميع
بحمايته!) ينقطع، وتبقى البلاد مجرد فراغ في صدرك. الليبي المنفي، المغترب، الذي
يتساءل بغضب عما تريدُ تلك البلاد من أولادها بعد، ألا يكفيها ما أخذته منهم؟! هذا
صوتٌ لا أظن أن العالم الخارجي سوف يسمعه، ولا أظن أن ليبيا سوف تسمعه بوضوح، ولكن
أي ليبي اغترب قليلاً سيسمعه ويفهمه جيداً.
لا أريد الحديث عن المعاني الكامنة في الرواية.
أظن أن أبرز معنى في هذه الرواية التي تقف فجأةً لتخاطب العالم هو أن هناك حقيقة
تقع تحت الشمس مباشرةً لا يراها العالم، حقيقة لا نهاية سينمائية سعيدة وبطولية
فيها. وربما هناك رسالة أخرى، رسالة ضمنية في علاقة سلومة بأمه نجوى، أمه التي
يمكنها أن تكون رمزاً لليبيا، الفتاة التي تزوجت رغماً عنها، والتي ربطتها علاقة
متقلبة بابنها، فهو يحبها ويريد إنقاذها، وأحياناً يكرهها ويغضب منها – ليبيا هي
أمنا التي نغيب عنها ونتفادى الاتصال بها، ولكن حين نراها نصيح بشوق "ماما!
ماما! ماما!". ربما هذه أبرز المعاني في الرواية. باقي الكلام نعرفه،
الليبيون عاشوه، كثيرون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم الثالث عاشوه
واختبروه جيداً. القارئ الأوروبي ستختلف ردة فعله مع هذه الرواية الأجنبية تماماً
عليه، القارئ الشرقي ستكون له ردة فعل أكثر وعياً بتفاصيل هذه الرواية، والقارئ
الليبي سيعرف كل شيء. والتجربة الشخصية لكل قارئ مختلف أيضاً ستحكم الأمر، ردة
فعلي المرتبطة بالرواية كثيراً على المستوى العاطفي ستبقى أبعد بكثير من ردة فعل
أحد أقربائي أو أصدقائي أو جيران طفولتي الذين اعُتقل أهاليهم مثلاً والذين سيكونون
أقرب للرواية. ردة فعلي على الجزء الأخير من الرواية وأنا مغترب سيختلف بلا شك عن
ردة فعل شخص لا يزال في ليبيا، وسيختلف عن ردة فعل شخص لم يضطر يوماً للتفكير في
مغادرة بلاده.
وبالحديث عن التجارب الشخصية في القراءة، فقد
كنتُ أشعر بنوع من الصدمة وأنا أقرأ الكتاب. صدمة أن يكون هشام مطر كاتباً بارعاً
لهذه الدرجة. كيف تأخرتُ في قراءة الكتاب لهذه الدرجة؟ كيف يمكن أن يكون هنالك
كاتب ليبي بهذا المستوى؟ لا توجد أية أخطاء في الكتاب!
هشام مطر كاتبٌ حقيقي، شاعرٌ حقيقي. إنه يُجيد
الوصف، والتقاط التفاصيل العابرة، يجيد وصف
مشاعر الناس وتحليلها، ويُجيد استخدام التشبيهات التي تجعل القارئ يفهم
تماماً ما يقصد (براعته في التشبيه براعة شاعر!)، كما يجيد السرد والتشويق. إن
خلاصة ذلك أن الرواية تكون عملاً أدبياً فنياً متقناً، وليس مجرد رواية مشوقة أو
سيرة ذاتية أو كتابة رجل يُحدث العالم عن مكان غريب اسمه ليبيا (أو الجماهيرية!).
أظن أنني وصلتُ إلى نهاية حديثي.. لا شيء جديد
حقاً في هذه "المراجعة"، إن جاز لي وصفها بذلك. هي فقط تجربتي الشخصية في قراءة هذا
الكتاب. لم أندم إطلاقاً على قراءة الكتاب، بل ندمت على تغافلي عن هذا الكاتب طيلة
هذه الفترة. أشعر بأن زمن هذا الكتاب قد ولى، خاصةً بعد سقوط القذافي وسقوط ليبيا
نفسها في جحيم مختلف كلياً الآن، وإن كان الكتاب يبقى (مثل الكثير من الأعمال
الكلاسيكية في الأدب العالمي التي استحق هشام مطر مكانه بجدارة بينها) يبقى شاهداً
على عصره. شاهداً يقول الحقيقة، وهذا شيءٌ نادرٌ جداً في عالم الأدب الخيالي...
هشام مطر كاتب حقيقي. وكتاب "في بلاد
الرجال" عمل فني حقيقي، حقيقي واقعياً وحقيقي فنياً...
ولقد كان كتاباً مرهقاً...
5 أبريل 2017.